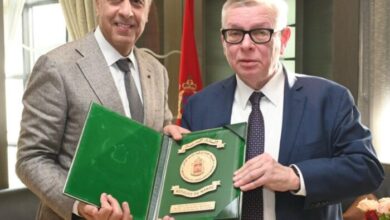في كل عام، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في العالم، وكأنها تمتلك شهادة أخلاقية دولية، وكأنها الدولة الوحيدة التي تفهم معنى الكرامة الإنسانية. وفي تقريرها الأخير حول المغرب، زعمت أن الوضع لم يتغير، وأن هناك انتهاكات مستمرة تتعلق بحرية التعبير، والاعتقالات الناشطة، وغياب الشفافية في بعض الملفات. لكن ما لا تقوله الخارجية الأمريكية هو أن هذا التقرير لا يقاس بالمبادئ، بل بالمصالح. لا يصدر بناء على العدالة، بل بناء على الولاءات الجيوسياسية. وهو، في جوهره، ليس تقريرا حقوقيا، بل أداة ضغط.
فكيف يمكن لدولة تعذب في سجونها، وتدمر شعوبا بطائراتها، أن تصبح مرجعية أخلاقية للعالم؟ كيف يمكن لمن يمارس التمييز العنصري داخل أراضيه أن يدين القيود على الحريات في بلد مثل المغرب، الذي لم يغز دولة، ولم يفجر مسجدا، ولم يهدم قرية؟ إنها الازدواجية التي باتت سمة ملازمة للسياسة الأمريكية، تدين الآخرين بالذنب الذي ترتكبه هي نفسها بدم بارد.
لنبدأ من الداخل. ففي الولايات المتحدة، لا تزال آثار العبودية حية في مجتمع يقتل فيه الأمريكيون الأفارقة على أيدي الشرطة، ليس بسبب جريمة، بل بسبب لون بشرتهم. جورج فلويد لم يعدم في ساحة عامة، بل في شارع عادي، على مرأى من الكاميرات، بينما كان يصرخ لا أستطيع التنفس. ورغم الهزات العالمية التي أثارتها الجريمة، لم يعاقب سوى الجاني المباشر، بينما بقي النظام العنصري سليما، قويا، متجذرا. فكيف تتحدث هذه الدولة عن المساواة والعدالة في تقريرها عن المغرب؟
أما على الحدود الجنوبية، فالمهاجرون غير الشرعيين، ومن بينهم أطفال، يحتجزون في أقفاص معدنية، تفصل العائلات، تهان الكرامة، وتنتهك الحريات. صور الأطفال البكاة في زنازين باردة انتشرت في العالم، لكن واشنطن واصلت سياساتها القمعية باسم الأمن الحدودي. وفي الوقت الذي تدين فيه المغرب بملف المهاجرين، تواصل الولايات المتحدة احتجاز آلاف البشر في ظروف لا إنسانية، ودون محاكمة، في سجون مثل غوانتانامو، التي لا تزال مفتوحة بعد أكثر من عقدين من الزمن.
ولن ننس جريمة القرن: إبادة شعب الهنود الحمر. لم تكن مجرد حرب، بل عملية تطهير عرقي منظمة، عبر القتل الجماعي، والتشريد، والجوع المفتعل. ملايين السكان الأصليين اختفوا من خريطة أمريكا، وتم محو ثقافاتهم، وسرقة أراضيهم. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة ترفض الاعتراف رسميا بهذه الجريمة، ولا تقدم اعتذارا حقيقيا، ولا تعوض القبائل. فكيف يمكن لدولة بهذا التاريخ أن تصدر أحكاما أخلاقية على دول أخرى؟
ولكن الازدواجية لا تقتصر على الداخل، بل تمتد إلى السياسة الخارجية، حيث تستخدم حقوق الإنسان كأداة سياسية، لا كمبدأ. في أفغانستان، قادت أمريكا حربا استمرت عقدين، دمرت خلالها البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وقتلت مئات الآلاف من المدنيين، ثم انسحبت في فوضى مخزية، تاركة الشعب الأفغاني يواجه الدمار. لم يكن الهدف نشر الديمقراطية، بل السيطرة الجيوسياسية. أما حقوق الإنسان، فكانت مجرد شعار على شفاه الدبلوماسيين.
وفي العراق، تم غزو دولة ذات سيادة تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل، التي تبين لاحقا أنها وهم. النتيجة؟ أكثر من مليون قتيل، وخراب شامل، وفضيحة سجن أبو غريب، حيث جنود أمريكيون يصورون أنفسهم وهم يعذبون ويهينون السجناء العراقيين. صور انتشرت في العالم، لكن لا أحد من كبار القادة دين. بينما اليوم، توجه أصابع الاتهام إلى المغرب بملف التعذيب، رغم أن مؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعمل بشفافية، وترفع تقارير دورية، وتدقق في الشكاوى.
أما في فلسطين، فالموقف الأمريكي لا يحتمل. تمول إسرائيل بعشرات المليارات سنويا، تحمى في مجلس الأمن من أي قرار عادل، وتستخدم الطائرات الأمريكية لقصف غزة، بينما يقتل الأطفال، وتهدم المنازل، وتستولي على الأراضي. ومع ذلك، لا يذكر في التقارير الأمريكية أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري، أو أن الاحتلال هو أصل المعاناة. بل توجه الأنظار نحو دول مثل المغرب، التي تحافظ على استقرارها، وتنفذ إصلاحات حقيقية في مجالات العدالة، والمرأة، وحرية التعبير.
وفي اليمن، تبيع الولايات المتحدة الأسلحة للسعودية، التي تستخدمها في قصف المستشفيات والمدارس، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. ملايين الأطفال يموتون جوعا، بينما تصدر واشنطن تقارير أخلاقية عن دول تعاني من أزمات أقل بكثير.
فهل يمكن لدولة بهذه السجلات أن تكون مرجعية في حقوق الإنسان؟
بالنسبة للمغرب، فإن التقرير الأمريكي يغفل الإصلاحات العميقة التي عرفها البلد: من دستور 2011 الذي منح صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، إلى إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية المستقلة، رغم التحديات. كما أن المغرب يعد من أكثر الدول استقرارا في منطقة تعاني من الحروب والفوضى، وهو نموذج للتعايش الديني والثقافي، يستقبل فيه المسلمون واليهود والمسيحيون بسلام.
لكن التقرير لا يتحدث عن هذا. يتحدث فقط عن الانتهاكات، دون سياق، ودون مقارنة، ودون عدالة. لأنه لا يهدف إلى تحسين حقوق الإنسان، بل إلى إرسال رسالة: كن مطيعا، وإلا سندخل ملفك في التقرير.
في النهاية، عندما يصبح المجرم محاضرا في حقوق الإنسان، فإن ذلك ليس مجرد تناقض، بل جريمة ضد المصداقية. فالمغرب لا يحتاج إلى شهادة من دولة تعذب في سجونها، وتدمر الشعوب بطائراتها، لتعرف إن كان يحترم حقوق الإنسان أم لا. فالمواطن المغربي يعرف قيم بلاده، ويدرك حجم الإصلاحات، ويقارن بين استقرار بلاده وفوضى الجوار.
أما على المجتمع الدولي، فالوقت قد حان لرفض هذه الازدواجية. فالعدالة لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، ولا يمكن أن تكون أداة للهيمنة. وحقوق الإنسان ليست سلعة أمريكية تباع للحلفاء، وتسلب من المعارضين.