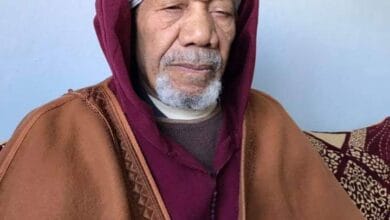الجيو تنوع والبيو تنوع والتنوع الثقافي : موارد ترابية قابلة للتعبئة والتثمين من أجل تنمية ترابية بالإقليم

الدكتور محمد ازلماط
إنه لمن دواعي البهجة والسرور، أن أتقدّم إليكم بهذه المداخلة التي تنضوي ضمن أشغال هذه الملتقى العلمي، والتي تحمل عنوانًا جامعًا لموضوع بالغ الأهمية: “الجيوتنوع، البيوتنوع، والتنوع الثقافي: موارد ترابية قابلة للتعبئة والتثمين من أجل تنمية ترابية مستدامة بإقليم صفرو.” وإنه يندرج ضمن الجغرافيا الثقافية التي تعد من الفروع المعرفية التي تهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان والمجال من منظور رمزي، هوياتي، واجتماعي. وتُسائل الجغرافيا الثقافية كيفية إنتاج المعنى داخل الفضاء، وتبحث في تجليات الثقافة داخل البنية الترابية. في هذا السياق، تظهر عناصر مثل الجيوتنوع، والبيوتنوع، والتنوع الثقافي كمرتكزات أساسية، ليس فقط لفهم المجال، بل أيضًا كدعائم محتملة لمشاريع التنمية الترابية.
يُشكل الجيوتنوع أحد أهم الموارد القابلة للتعبئة، لما يحمله من إمكانات جيومورفولوجية، ومكونات طبيعية قابلة للتثمين. فالجبال، والوديان، والكثبان، والتكوينات الصخرية، ليست فقط معالم طبيعية، بل تُمثّل دعامات لتشكيل هوية المكان، وتلعب دورًا مهمًا في تنمية السياحة البيئية والثقافية. كما أن المواد المحلية المستخرجة من الجيوتنوع تُوظف في المعمار التقليدي، مما يمنح للتراث العمراني طابعًا متجذرًا في البيئة. هكذا، يبرز الجيوتنوع كعنصر رئيس في إنتاج المجال وإعادة تأطيره تنمويًا.
أما البيوتنوع، فيحضر كعنصر حيوي في الفعل التنموي، نظرًا لما يزخر به من تنوع نباتي وحيواني يُستثمر في عدة مجالات. تُشكل المعارف المحلية المرتبطة بالنباتات الطبية، والزراعات التقليدية، وتربية الماشية، أساسًا لرؤية تنموية ترتكز على الاستدامة والاقتصاد الاجتماعي. كما أن البيوتنوع يُغذي السياحة البيئية، ويُعزز من إمكانات الاقتصاد القروي المرتبط بالهوية المجالية. من هنا، يُمكن القول إن البيوتنوع لا يكتفي بوظائفه البيئية، بل يتحول إلى رأسمال بيئي ـ ثقافي قابل للتثمين.
أما التنوع الثقافي، فهو في صلب الجغرافيا الثقافية، باعتباره تجليًا لتفاعل الإنسان مع المكان، وتاريخًا متراكمًا من المعارف، والعادات، والتمثلات. يُساهم التنوع الثقافي في بناء رأس المال الرمزي للتراب، من خلال الألسن المتعددة، والتقاليد، والطقوس، والحرف، والممارسات المجالية. وتُستثمر هذه الأبعاد في مجالات مثل السياحة الثقافية، والتعليم، وتنشيط الحياة المجالية عبر المهرجانات والاحتفالات المحلية. كما يُشكّل التنوع الثقافي إطارًا لاستثمار المعارف التقليدية في البناء، والفلاحة، وتدبير الماء، مما يعزز قيم الاكتفاء الذاتي والاستدامة.
وعليه، فإن الجيوتنوع، والبيوتنوع، والتنوع الثقافي لا يمكن اختزالها في كونها مجرد مكونات مادية أو رمزية، بل يمكن اعتبارها في الوقت نفسه عناصر من الجغرافيا الثقافية، وآليات فاعلة في دينامية التنمية الترابية. فهي تُسهم في إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والمجال، وتُقدم بدائل تنموية نابعة من الأرض، ومن الخصوصيات المحلية، وتسعى إلى إحداث قطيعة مع نماذج تنموية نمطية غير متلائمة مع السياقات الترابية الدقيقة.
ويُعد إقليم صفرو من الأقاليم المغربية التي تزخر بهذه الأبعاد الثلاثة بشكل لافت. فهو يمتلك رصيدًا ترابيًا متنوعًا، تتداخل فيه الجغرافيا مع الإيكولوجيا، وينسج فيه الإنسان ذاكرة غنية من التقاليد والمعارف والممارسات. وتكمن أهمية هذه الموارد في قابليتها للتثمين في إطار استراتيجيات تنموية محلية مستدامة، تستحضر البعد البيئي والثقافي والاجتماعي، وتُراهن على تنمية تستند إلى الخصوصيات الترابية.
فعلى مستوى الجيوتنوع، يتميّز الإقليم بتضاريس متباينة تشمل الجبال والهضاب والوديان، إضافة إلى وجود تكوينات جيولوجية فريدة ،مما يفتح المجال أمام أنشطة علمية وسياحية بيئية كزيارة الكهوف والشلالات ومواقع الصخور النادرة، نذكر منها مثلًا مناطق إيموزار كندر والبهاليل. هذه المواقع تمثل فضاءات طبيعية وسياحية وتعليمية، وتُعد مختبرًا مفتوحًا لعلوم الأرض ومواردها، كما تُسهم في خلق مناصب شغل محلية وتحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة.
أما البيوتنوع، يشكل التنوع البيولوجي والتراث الثقافي موارد ترابية ذات قيمة استراتيجية يمكن تثمينها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. فالتنوع البيولوجي، الذي يشمل النظم البيئية والأنواع الحيوانية والنباتية الفريدة، يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على التوازن البيئي وضمان الأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعات المستدامة واستغلال النباتات الطبية والعطرية. ويؤطره القانون الإطار المتمثل في ظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 ( 6 مارس 2014 ) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة[1].وظهير شريف رقم 1.03.59 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة[2].وظهير شريف رقم 1.03.60 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة[3].وظهير شريف رقم 1.20.78 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 ( 8 أغسطس 2020 ) بتنفيذ القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي[4].ظهير شريف رقم 1.03.61 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء[5].
وفي هذا الإطار، وقعت المملكة المغربية خلال قمة الأرض التي انعقدت سنة 1992، على اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) وصادقت عليها في 21 غشت 1995 والتي أكدت على الأهمية القصوى التي توليها بلادنا لثروتها الحية ومواردها البيولوجية، بما في ذلك النظم الإيكولوجية والأنواع الحية.وإن هذا التنوع يوفر فرصًا كبيرة للسياحة البيئية، من خلال استثمار المحميات الطبيعية والمسارات الجبلية والمواقع الغنية بالتنوع الإيكولوجي، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي.
فيتجلّى في الغطاء الغابوي الواسع المتنوع (غابة بوعادل، أهرمومو…)، وفي تنوع الأنظمة البيئية الغنية بالنباتات والحيوانات، التي تجعل من الإقليم مجالًا بيئيًا حيويًا للحفاظ على التوازن الطبيعي، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، خاصةً في ظل التحديات البيئية المعاصرة. وتتجلى أهمية هذا الغنى البيئي في ما توفره المنطقة من عيون مائية وأنهار وخدمات إيكولوجية تُدعم الزراعة المستدامة والإنتاج المحلي.
أما التنوع الثقافي في صفرو يُعد من أبرز مكونات الهوية الترابية، حيث يشتهر بتراثه غير المادي، مثل مهرجان حب الملوك المصنف تراثًا عالميًا من قبل اليونسكو، إضافة إلى التراث المعماري التقليدي والموروث الأمازيغي واليهودي الذي يعكس تعددية ثقافية نادرة. سيما في تعدد الأعلام والمفكرين التابعين لقبائل هذا الإقليم فهذه الخصوصية تجعل الإقليم نموذجًا وطنياً للتعايش الثقافي، ما يفتح المجال أمام مبادرات تثمين التراث من خلال السياحة الثقافية ودعم الحرف التقليدية وتبرز مظاهر هذا التنوع الثقافي في عدة تمظهرات:
- على المستوى اللامادي، نجد ممارسات ومناسبات احتفالية ذات طابع رمزي عريق، أبرزها مهرجان حب الملوك، الذي يُصنف كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو، والذي يجسد ليس فقط فعالية فنية أو تجارية، بل تقليدًا جماعيًا محليًا يؤسس لروح الجماعة ويُعزز من تماسك النسيج الاجتماعي.
- أما على المستوى المعمار التقليدي، فتبرز المدن القديمة والقرى ذات الهندسة الأصيلة، كما هو الحال في البهاليل التي تُعرف بمساكنها الكهفية، وصفرو المدينة بسوقها العتيق ومعمارها المغربي الأندلسي الأصيل.
- كما أن الإرث الأمازيغي واليهودي يُعد مكونًا أساسيًا في الهوية الترابية، ويتجلّى في اللغة، والحِرف، والموسيقى، والمأكولات، واللباس، وحتى في طقوس الحياة اليومية، مما يمنح الإقليم بعدًا ثقافيًا متنوعًا وثريًا، يمكن استثماره في السياحة الثقافية، وفي مشاريع تثمين الذاكرة الجماعية.
التنوع الثقافي يتمثل في عديد من الأنواع الأدبية الشفوية، كالشعر، احيدوس، أهلل، تماويت والمناطق فهي تعكس الهوية الثقافية للاقليم وتعبر عن مظاهر الحياة الاجتماعية لسكانها، ففي سياق الجهوية المتقدمة، منحت القوانين التنظيمية (111.14، 112.14، 113.14) المتعلقة بمستويات الحكامة الترابية الثلاثة (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بالمجال الثقافي وتنوعه، وذلك استنادًا إلى مبدأ التفريع. وفي إطار اختصاصاتها الذاتية، تلعب الجهات دورًا مهمًا في الحفاظ على المواقع الأثرية وتثمينها، إلى جانب تنظيم الفعاليات والمهرجانات الثقافية.كما تضطلع العمالات والأقاليم بمسؤولية تشخيص الحاجيات الثقافية على المستوى المحلي، مما يساهم في توجيه السياسات الثقافية بشكل أكثر دقة وفعالية.أما الجماعات، فقد أوكلت إليها مهام إنشاء المتاحف والمسارح ومعاهد الفنون والموسيقى، بالإضافة إلى حماية الخصوصيات التراثية المحلية والعمل على تنميتها. وتشمل هذه المهام أيضًا صون المعالم التاريخية وترميمها للحفاظ على قيمتها الحضارية. ومن جهة أخرى، يمكن أن يتحول التراث الثقافي المحلي إلى رافعة لتعزيز هوية مجال ترابي معين، مما يساهم في رفع جاذبيته وتنافسيته على المستويين الاقتصادي والسياحي.
- ولا يمكن إغفال الجانب العلمي، حيث أن الإقليم أنجب شخصيات فكرية بارزة أسهمت في بناء الذاكرة الثقافية المغربية، مثل أبوجيدة ابن أحمد اليزغتني، أبو الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي ويوسف بن عمران المزدغي، وأبو محمد قاسم بن عبد العزيز اللواتي وابن بطوطة الواتي ،ابن آجروم الصنهاجي. الذي يرجع أصله الى قبيلة صنهاجة الأمازيغية المشهورة،وسيدي محمد بن عيسى وأبو الحجاج يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي وأبو عبدالله محمد بن موسى الأزكانبي سالم العياشي وأبو سرغين وأبو عبد الله محمد بن يحيى البهلولي[6].وغيرهم، مما يعزز من مكانة صفرو كحاضنة ثقافية على الصعيد الوطني.
إن التنوع الثقافي هنا لا يُعد مظهرًا تراثيًا فحسب، بل هو مورد تنموي قابل للتثمين في إطار اقتصاد الثقافة، ورافعة استراتيجية لتعزيز الهوية الترابية، وتحفيز الاستثمار السياحي، وبناء نموذج تنموي يقوم على التعدد والانفتاح والاستدامة.
الاستثمار في الجيوتنوع والبيوتنوع والتنوع الثقافي:
تُعتبر التنمية المستدامة اليوم، وفي سياق إقليم صفرو، مشروعًا شموليًا يتطلب تكامل وتنسيق بين الجوانب البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية، وبالأخص بين الجيوتنوع، البيوتنوع، والتنوع الثقافي. فاستثمار هذه الموارد الترابية بشكل مدروس ومتوازن يُمكن أن يُحدث تحولًا نوعيًا في ديناميكيات التنمية المحلية، ويُسهم في إحداث فرص اقتصادية جديدة للمجتمع المحلي.
أولًا: الاستثمار في الجيوتنوع
يُمكن استثمار الجيوتنوع من خلال تطوير مشاريع السياحة الجيولوجية التي تستغل التكوينات الجيولوجية المميزة، مثل الوديان العميقة، الكهوف، والمناطق الجبلية، مما يعزز من قدرات المنطقة على جذب السياح من داخل المغرب وخارجه. يمكن أيضًا إقامة مراكز بحثية موجهة لدراسة الزلازل، الوديان الجافة، والظواهر الطبيعية التي تجعل المنطقة فريدة، مما يساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في الاقتصاد المعرفي.
ثانيًا: الاستثمار في البيوتنوع
التنوع البيئي والغطاء الغابوي الذي تتمتع به صفرو يُعدّ من بين أهم الأصول التي يُمكن أن تُسهم في تنمية مستدامة. فاستثمار الموارد البيئية في السياحة البيئية من خلال المسارات الطبيعية، رحلات السفاري، ومراقبة الطيور والحياة البرية، يمكن أن يُحفز السياحة البيئية، ويُساهم في تعزيز الوعي البيئي وحماية هذه الأنظمة البيئية الهشة. كما يمكن استثمار الموارد البيئية في الزراعة المستدامة، حيث يمكن تطوير الزراعة العضوية وحماية الغطاء النباتي، وهو ما يُساهم في تحسين الأمن الغذائي لسكان المنطقة.
ثالثًا: الاستثمار في التنوع الثقافي
إن التنوع الثقافي في إقليم صفرو يمثل أحد الأبعاد الجوهرية التي يمكن البناء عليها لتطوير الصناعات الثقافية، سواء من خلال إعادة تأهيل المواقع التاريخية، مثل القرى الأمازيغية القديمة والمنازل التقليدية، أو من خلال المهرجانات الثقافية والفنية التي تُساهم في خلق فرص العمل للمجتمع المحلي وتعمل على الترويج للثقافة المحلية عبر برامج دولية.
في هذا السياق، يُمكن إدماج التنوع الثقافي في الاقتصاد الإبداعي من خلال تطوير المنتجات اليدوية المستوحاة من التراث المحلي، مثل الحرف التقليدية كالخزف، النسيج، والموسيقى الشعبية، التي تُعد من أبرز مقومات الثقافة الأمازيغية واليهودية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن تطوير الطعام التقليدي في إطار السياحة المستدامة، مما يُوفر فرصًا جديدة لتسويق المنتجات المحلية وزيادة الدخل المحلي.
فإن تثمينه يتطلب استراتيجيات تحافظ على التراث المادي وغير المادي وتستغله اقتصاديًا واجتماعيًا. يتمثل ذلك في دعم الحرف التقليدية عبر تأهيل الصناع التقليديين، مثل صناعة الأزرار الحريرية أو ما يعرف ب “العقاد” بوجود المغاربة اليهود بإقليم صفرو بالمغرب[7] ، وأضحت اليوم قطاعا صناعيا مهما يساهم بشكل كبير في تحسين مداخيل المئات من النساء ويرفع من مستواهن المعيشي. وإنشاء فضاءات لعرض وبيع المنتجات المحلية، وتوفير حماية قانونية للمنتجات التراثية من التقليد. كما أن إدماج التراث الثقافي في عروض السياحة الثقافية، من خلال تنظيم مهرجانات وفعاليات تروج للموروث المحلي، يساهم في تعزيز الارتباط بالهوية وتحفيز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يشكل التعليم والثقافة ركيزة أساسية في ترسيخ التنوع الثقافي، من خلال إدماج التراث في المناهج الدراسية، ودعم الأبحاث حول التقاليد والعادات المحلية. يشكل التراث المادي وغير المادي لإقليم صفرو ركيزة مهمة يمكن استثمارها في التنمية المستدامة. يشمل هذا التراث فنون الصناعة التقليدية، الفلكلور، العادات والتقاليد، والمهرجانات، وأبرزها مهرجان حب الملوك الذي يعد تراثًا ثقافيًا لاماديًا يمكن توظيفه كأداة للترويج السياحي للإقليم. ومن بين آليات التثمين المستدام، يمكن دعم الصناع التقليديين عبر تحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع، وخلق فضاءات لعرض وبيع المنتجات الحرفية، فضلاً عن توفير حماية قانونية للمنتجات التراثية المحلية من التقليد. كما أن رقمنة التراث وتوثيقه يتيح إمكانيات واسعة للترويج له على المستوى الوطني والدولي.
على مستوى السياسات العمومية، يتطلب التثمين المستدام لهذه الموارد تعزيز الحكامة البيئية والثقافية، عبر وضع أطر قانونية تحمي المواقع الجيولوجية، الأنظمة البيئية، والموروث الثقافي. كما أن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني يساهم في تنسيق الجهود وتحقيق الاستدامة. وتشكل الرقمنة أداة فعالة في هذا المجال، إذ يمكن من خلالها توثيق الموارد الترابية والترويج لها على نطاق واسع، مما يسهل عملية تثمينها محليًا ودوليًا. و يتطلب التثمين المستدام لهذه الموارد اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الفاعلين المحليين، من مجالس ترابية، وجمعيات، وقطاع خاص، لضمان التدبير المستدام للمجال. ويعتمد التثمين المستدام للموارد الجيوتنوع والبيوتنوع والتنوع الثقافي على مقاربة متكاملة تجمع بين الحماية، الاستغلال الرشيد، والترويج الذكي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تجمع بين الفوائد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية. فإن تثمين الموارد الترابية بإقليم صفرو يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على الموارد واستثمارها بطرق مبتكرة، من خلال السياحة الجيولوجية والبيئية، استغلال النباتات الطبية والعطرية، دعم الصناعة التقليدية، والترويج للتراث الثقافي، مع اعتماد سياسات حكامة بيئية وثقافية تضمن استدامة هذه الموارد لفائدة الأجيال القادمة.
التحديات والفرص في التنمية المستدامة:
رغم الجهود المتواصلة لتنمية إقليم صفرو عبر الاستفادة من الجيوتنوع، البيوتنوع، والتنوع الثقافي، إلا أن هذه المبادرات تواجه العديد من التحديات، نذكر منها:
- التحديات البيئية: مثل قلة الموارد المائية والتصحر، والتي تتطلب تبني استراتيجيات فعالة للمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من آثار التغيرات المناخية.
- التحديات الاقتصادية: مثل نقص التمويل في القطاع الثقافي والإيكولوجي، حيث تتطلب مشروعات التنمية المستدامة استثمارات عالية وموارد مالية كبيرة.
- التحديات الاجتماعية: مثل محدودية الوعي البيئي والثقافي لدى بعض الفئات الاجتماعية، مما يستدعي تنمية ثقافة الاستدامة والحفاظ على التراث.
على الرغم من هذه التحديات، فإن هناك فرصًا كبيرة لتنمية إقليم صفرو، وتتمثل هذه الفرص في:
- دور الجمعيات المحلية: التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في رفع الوعي حول أهمية الجيوتنوع، البيوتنوع، والتن diversification in development projects.
- دعم السياسات الحكومية: التي تركز على تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للاستثمار في القطاعات الإيكولوجية والثقافية.
فإقليم صفرو، بثرواته الجيوبيئية والثقافية، يحمل بين تضاريسه وتاريخه إمكانيات ضخمة لتفعيل التنمية الترابية المستدامة. غير أن النجاح في ذلك مشروط بوجود رؤية استراتيجية متكاملة، تُشرك الساكنة، وتعتمد على مقاربات بيئية، وتربط بين حماية التراث واستثماره في آن واحد.
خاتمة
بعد استعراض مدى حضور الجيوتنوع، والبيوتنوع، والتنوع الثقافي في موارد ترابية قابلة للتعبئة والتثمين من أجل تحقيق تنمية ترابية بالإقليم، يتضح أن هذه الأبعاد الثلاثة ليست مجرد مكونات طبيعية أو رمزية معزولة، بل تمثل روافع استراتيجية للتنمية المستدامة، لما تختزنه من إمكانات بيئية واقتصادية وثقافية قادرة على دعم مشاريع مجالية مندمجة، تنطلق من الخصوصيات المحلية وتستجيب للتحولات الوطنية والدولية.
يمكن الوقوف على مجموعة من النتائج والخلاصات التي تبرز أهمية هذه المكونات في هندسة تنمية ترابية قائمة على الاستدامة، والعدالة المجالية، والخصوصيات المحلية.
أولًا: النتائج والخلاصات
يتبين من التحليل أن الجيوتنوع والبيوتنوع لا يشكلان فقط خلفية طبيعية صامتة، بل هما موارد حية ومتجددة، تتيح فرصًا كبيرة للاستثمار البيئي والسياحي والفلاحي. كما يتضح أن التنوع الثقافي، بوصفه رصيدًا رمزيًا ومعرفيًا، يمثل مفتاحًا لإعادة تأهيل المجال وتنشيط الدينامية الاجتماعية والاقتصادية من داخل التراب، بدل فرض نماذج جاهزة من خارجه.
وتؤكد القراءة المجالية أن الجغرافيا الثقافية بوصفها علمًا تقاطعيًا، تسمح بفهم دقيق للكيفية التي يتفاعل بها الإنسان مع محيطه، من خلال ثقافته وبيئته وموارده، مما يعزز من دور البعد الثقافي كأداة للتمايز الترابي وصياغة مشروع تنموي متجذر محليًا.
ثانيًا: الاقتراحات
- إدماج الجيوتنوع والبيوتنوع والتنوع الثقافي بشكل مؤسسي في السياسات الترابية، من خلال إنشاء خرائط وظيفية لهذه الموارد تساعد على التثمين المسؤول.
- تعزيز البحث العلمي الميداني في مجالات الجغرافيا الثقافية، وربطه ببرامج التنمية الترابية، خاصة في الجهات ذات الغنى الطبيعي والثقافي.
- تشجيع الفاعلين الترابيين والجماعات الترابية على اعتماد مقاربات تشاركية، تقوم على تثمين المعارف المحلية وربطها بالابتكار الاجتماعي والاقتصاد التضامني.
- إدراج التربية على الجغرافيا الثقافية في المناهج التعليمية، لترسيخ الوعي بالموارد الترابية في أجيال المستقبل.
- في إطار مواكبة الديناميات المجالية والتحولات الرقمية المتسارعة، يُقترح تخصيص الملتقى القادم لموضوع محوري حول حكامة ترابية ذكية: استشراف مستقبل الجماعات الترابية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليتناول آفاق إعادة صياغة السياسات الترابية في ضوء الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يُمكن الجماعات الترابية من الانتقال نحو نموذج تنموي مبتكر، شمولي، ومستدام.
وسيكون من المهم في هذا السياق، الانفتاح على كيفية إدماج الثروات غير المادية، مثل التنوع البيئي، الجغرافي، والثقافي، ضمن الرؤية التنموية للجماعات، بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد في بناء مشاريع تنموية تراعي الخصوصيات الثقافية المحلية وتستثمر الذكاء الترابي في خدمة المواطن والمرتفق.
كما يُقترح أن يتناول النقاش سبل إعادة هيكلة أدوات التخطيط والتدبير المحلي من خلال استثمار التقنيات الذكية وتطوير آليات رقمية تُعزز من التواصل، الشفافية، واتخاذ القرار، بما يواكب تحديات التحولات البيئية والاجتماعية، ويساهم في تعزيز صمود الجماعات الترابية أمام الأزمات.
الغاية من هذا النقاش ليست فقط طرح تصورات نظرية، بل الانخراط في بلورة رؤى عملية وتشاركية بين مختلف الفاعلين الترابيين، من أجل التأسيس لسياسات عمومية قادرة على التكيف، والاستباق، والتجديد
.ثالثًا: الأفق المستقبلي للموضوع
ينفتح موضوع الجغرافيا الثقافية والموارد الترابية في علاقته بالتدبير الجماعات الترابية على آفاق بحثية جديدة، من خلال ربطه بالتحولات المناخية، والتقنيات الذكية، والسياحة الإيكولوجية، واقتصاد المعرفة. كما أن تطور أدوات التمثيل الجغرافي (GIS) يسمح برؤية أدق لحركية الموارد والتفاعلات الثقافية، ما يدعم قدرة الفاعلين على اتخاذ قرارات أكثر دقة ونجاعة.
رابعًا: الأفق المستقبلي للفاعلين السياسيين
أمام الفاعلين السياسيين فرصة استراتيجية لإعادة صياغة النموذج التنموي على أسس ترابية ثقافية بيئية، من خلال رؤية مندمجة لا تختزل التنمية في المؤشرات الاقتصادية فقط، بل توسعها لتشمل المعنى، والهوية، والاستدامة. كما أن تحولات الدولة نحو الجهوية المتقدمة واللامركزية المتلازمة باللاتمركز الاداري تمنح الفاعل السياسي المحلي هامشًا أكبر لإبداع حلول تنموية ترتكز على الخصوصيات المجالية بدل الاستنساخ.
وعليه، فإن إعادة الاعتبار للجيوتنوع، والبيوتنوع، والتنوع الثقافي ضمن منظور الجغرافيا الثقافية في علاقتها بالتدبير الترابي يشكل خطوة حاسمة نحو تنمية ترابية عادلة، متجددة، ومستدامة.
وشكرًا على حسن الإصغاء.
[1] الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)
[2] الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)
[3] الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)
[4] الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 23 ذو الحجة (19 غشت 2020)
[5] الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003
[6] الكتابة العامة لإقليم صفرو: منوغرافية إقليم صفرو، 1991، ص17
[7] Benhalima.H: petites villes traditionnelles imitations socio-économique au maroc, le cas de Sefrou ; publication de la faculté des lettres et des sciences humaines ; Rabat ;1987 p : 17.